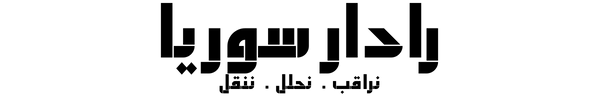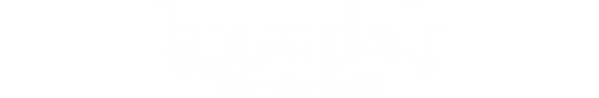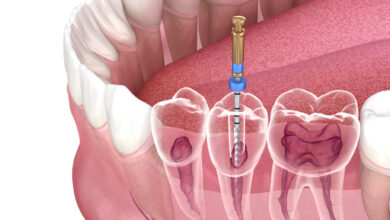دمشق تبحث فرص الاستثمار الصحي مع شركة إنتر هيلث العالمية

رادار سوريا – دمشق
في خطوة تهدف إلى دعم تعافي القطاع الصحي السوري، عقد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي اجتماعاً مع عماد دغير، رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني ورئيس مجلس إدارة شركة إنتر هيلث العالمية، لمناقشة آليات الاستثمار في البنية التحتية الصحية في سوريا.
اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصحة تناول إمكانيات تأسيس شراكات استراتيجية لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يواكب المعايير الدولية في الرعاية الصحية.
وتُعد شركة إنتر هيلث من المؤسسات الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الطبية، حيث تجمع بين الجودة العالية والتقنيات الحديثة والخبرة المهنية، بالإضافة إلى اهتمامها المستمر بالبحث العلمي والتطوير.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مساعي الحكومة السورية لجذب استثمارات نوعية تسهم في إعادة بناء القطاع الصحي، وخلق بيئة صحية مستدامة قادرة على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة.