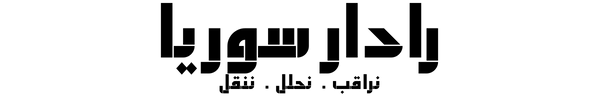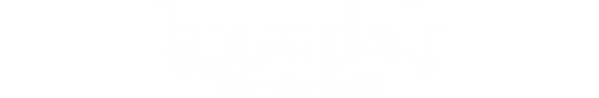الجولاني يُعرّف الوطن بالبندقية... ونحن نُعرّفه بالحوار

كارولِين الشَّامِي – ناشِطَةٌ سِياسِيَّةٌ وكاتِبَةٌ حُقوقِيَّةٌ نِسْوِيَّة
عندما قلنا ونكرر القول إن الجولاني، إن كان جاداً في بناء مستقبل سياسي مشروع، يجب أن يكسب شرعيته من الداخل أولاً، لا من الخارج، وأن يفتح باب الحوار الحقيقي مع مختلف مكوّنات النسيج السوري قبل أن يُلقي بنفسه في حضن اللاعبين الإقليميين، وقلنا إن الحل لا يكون بقبضة السلاح وحدها، اتُهِمْنا بأننا من الفلول والأذناب الإيرانيين و أصحاب الطرح العاطفي غير الواقعي.
هكذا، بكل بساطة، أصبح من يطالب بعملية انتقال سياسي حقيقية شاملة خاضعة للإرادة الشعبية، وبفتح حوار وطني واسع يُنتج عقداً اجتماعياً جديداً، يُتَّهَم بالخيانة أو بالرومانسية السياسية.
قلنا وسنقول دوماً إن السلطة التي تُبنى فقط بالبندقية، ستنهار بنفس البندقية. التاريخ لم يرحم أحداً. ولن يصنع الجولاني مستقبلاً آمناً إن لم يُشرك السوريين جميعاً في صناعة هذا المستقبل، من مختلف الأعراق والمذاهب والانتماءات الفكرية. لا يمكن أن تستمر سلطته على أرضٍ أنهكها النزف والمقصود هنا الشمال السوري وليس الشام، إن لم تتحول إلى مشروع جامع لا إقصائي.
واقترحنا حلاً وسطاً: لا نُسلِّم للنظام، ولا نكرّس واقع الانقسام. نريد حواراً وطنياً مسؤولاً،
يُشرك النخب والكفاءات المدنية والسياسية، ويُفضي إلى دستور مدني علماني، يحفظ الحقوق والحريات، ويضمن العدالة الانتقالية.
فجاء الرد ساخراً، متعجرفاً: هذا ليس وقته، من يُحرر يقرر، أين كنتم منذ 14 سنة؟ لماذا لم تتحدثوا حين كان الأسد يفتك بالشعب؟ لماذا لم تطلبوا منه ذلك؟
والجواب بسيط: لذلك بالضبط قامت الثورة.
قامت لأن الأسد لم يُتح حواراً ولا انتقالاً، ولم يفتح المجال أمام الشعب ليكون صاحب قراره. خرجنا لأن الاستبداد أغلق كل الأبواب. لكن أن يُعاد إنتاج الاستبداد بوجه جديد، بلباس ديني أو شعارات ثورية فارغة، فذلك خيانة لدماء الضحايا، وإهانة لأحلام الجياع للحرية.
إن الثورة ليست مجرد إسقاط شخص، بل إسقاط نمط حكم قائم على الإقصاء والاستئثار. وإن كانت هذه المرحلة الانتقالية لا تعترف إلا بمن يُصفق، ولا تقبل النقد إلا بوصفه خيانة، فبئس المرحلة وبئس الانتقال.
لسنا من الفلول، ولسنا أذناباً لأحد. نحن ببساطة، أبناء هذا الوطن، نقول ما نراه حقاً، ولو لم يُرضِ المُسلّح، ولا الشارع المتعصّب، ولا حسابات الخارج.
وما زلنا نؤمن: لا مستقبل لسوريا بلا مدنية، بلا علمانية، بلا عدالة، وبلا حوار.
سقوط الأقنعة في السويداء: حين تتعرى الشعارات أمام واقع الدم
الأحداث الأخيرة في السويداء لم تكن مجرد مواجهة عابرة، بل لحظة مفصلية سقطت فيها كثير من الأقنعة والشعارات. سقط معها ادّعاء الجولاني بأنه سيتولى المعارك ضد تنظيم داعش. إذ رأينا داعش، ومعها الفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة من تركيا، وحتى بعض التشكيلات البدوية، تقاتل إلى جانب الجولاني في خندق واحد، وبانسجام ميداني يثير أكثر من سؤال.
فأين هي الحرب المزعومة على الإرهاب؟
أين هو المشروع الوطني الذي تغنّى به الإعلام التابع له؟
لقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن عقلية الفاتح وزعيم العصابات المسلحة لا تزال هي الحاكمة، وأن الحروب تُدار بذهنية التفوق العرقي والطائفي لا برؤية دولة.
الخطاب السياسي الناعم الذي كان يروّج له الجولاني، ويُقدَّم للداخل والخارج كتحوّل سياسي نحو الاعتدال، لم يكن سوى مرحلة انتقالية لخداع الرأي العام، وتهدئة الخارج بانتظار تمرير مشروعه الأكبر: تقديم التنازلات التكتيكية للغرب، والتقارب مع إسرائيل ضمنياً، مقابل تسهيل مشروعه الداخلي القائم على إعادة صياغة المجتمع السوري وفق منطق التطهير الإثني والطائفي، ثم فرض دولة إسلامية متطرفة بغطاء زائف من إرادة الشعب.
لكن الجولاني رغم كل محاولاته يعلم أن تحقيق هذا المشروع مرهون بإسكات الأصوات المعارضة، وإخضاع المناطق ذات الإدارة الذاتية التي ترفض سلطته، ولا تعترف بدستوره الذي يُمنحه كل الصلاحيات دون أي محاسبة. إنه دستور يُصاغ على مقاس الزعيم، لا على مقاس الوطن، وتُقصى فيه كل القوى التي لا تركع، ولا تبايع، ولا تتبع.
ما حدث في السويداء كشف بوضوح أن القضية ليست محاربة الإرهاب، بل إعادة تدويره وتوظيفه ضمن استراتيجية توسعية تعتمد القوة لا السياسة، والإقصاء لا التشاركية، والولاء لا الكفاءة.
والواقع أن مشروع الجولاني بتكوينه هذا لا يقل خطراً عن المشروع الأسدي الذي ثُرنا ضده قبل أكثر من عقد. فكلاهما وجهان لسلطة استبدادية، تتغذى من الدم، وتخشى الديمقراطية، وتقاوم التعدد.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن نقولها بوضوح: ما نريده ليس قائداً جديداً بعقلية قديمة، بل دولة جديدة بعقد اجتماعي عادل، تشاركي، مدني، وعلماني.
نريد دولة لا يحكمها زعيم ميليشيا، ولا يتحكم بها مزاج المتغلب، ولا تُفرض على شعبها هوية قسرية باسم الدين أو القومية.
وإن كنا لا نزال نمتلك صوتاً حراً، فإننا نرفض أن نكون شهود زور على ولادة استبداد جديد باسم الثورة.
ودائماً ما نُواجَه بسؤال من قِبل المؤيدين التنظيريين حول الحلول والبدائل، معتقدين أن بهذا التساؤل قد بنوا سدّاً منيعاً أمامنا، ولا توجد حلول طُرحت على أرض الواقع، ومنها الفيدرالية اللامركزية نموذجاً.
اللامركزية كتهديد للسلطة: رفض الجولاني للفيدرالية بين الحُكم والديناميكيات الطائفية
منذ تحوّله من أمير في جماعة جهادية إلى حاكم فعلي في الشمال السوري، يواصل أبو محمد الجولاني، المعروف بلقب الشرع، فرض رؤيته السلطوية على مستقبل المنطقة، معارضاً أي صيغة للحكم لا تضمن له البقاء في مركز القرار. وفي هذا السياق، يُعد رفضه الصريح لفكرة اللامركزية أو الفيدرالية دليلاً على عمق تعارض مشروعه مع أي حل سياسي شامل يخرج سوريا من أزمتها المزمنة.
رفض الشرع للفيدرالية لم ينبع من منطلق وطني أو وحدوي، بل من خوفٍ سياسي وجودي؛ ذلك أن اللامركزية تعني تقاسم السلطة، وتوزيع القرار، وتفكيك الهيمنة الأحادية التي تتيح له التحكم بمفاصل المنطقة اقتصادياً وأمنياً وعقائدياً.
بينما كانت اللامركزية خياراً واعدًا لحل الكثير من المعضلات السورية، أصرّ الشرع على معارضتها لأنها تقوّض جوهر سلطته. فلو طُبّقت هذه الصيغة:
- لتمكنت المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها ذاتياً، وفقاً لهويتها الثقافية والدينية والسياسية، دون خضوع لإملاءات تيارات متطرفة أو جماعات مسلحة.
- ولُخُفّف التوتر الطائفي، بمنح الطوائف والمكوّنات السورية هامشاً من الأمان والكرامة، بعيداً عن سطوة التكفير والتخوين والانتقام.
- ولأمكن حصر الجهاديين والتكفيريين في أطر مدنية أو مناطق محددة، بدلاً من إطلاق يدهم على كل من يخالفهم في العقيدة أو الرأي، مما يمنع التنكيل بالطوائف الأخرى ويقلل من التوحش الأمني.
- وكانت ستفتح الأفق أمام حلول سياسية واقعية تضمن مشاركة أوسع من القوى المدنية، وتعيد بناء الثقة بين السوريين.
لكن الشرع، الذي يُدير المنطقة بذهنية الأمير وزعيم العصابة المسلحة، لا يقبل بمثل هذا الانفتاح. فاللامركزية تعني ببساطة انتهاء حلم الزعامة المطلقة، وانكشاف محدودية شرعيته السياسية والشعبية.
ومن المثير للسخرية أن الشرع، الذي يتحدث أحياناً بلغة التكنوقراط والسياسة، لا يزال يرتكز في حكمه على القوة المسلحة والعقيدة القتالية، متجاهلاً أن السوريين دفعوا أثماناً باهظة للخلاص من مثل هذه الأنظمة الاستبدادية، سواء لبست ثوب القومية أو الدين أو الثورة.
إن الإصرار على رفض اللامركزية من قِبل الجولاني ليس فقط عائقاً أمام بناء الدولة السورية، بل هو أيضاً استمرار لإنتاج نظام شبيه بالأسد، ولكن بلباس مختلف. ففي كلا النموذجين، تُحتَكر السلطة، ويُقمع المخالف، ويُستثمر الدين والطائفة والدم في سبيل البقاء.
ما تحتاجه سوريا هو تفكيك هذه البُنى السلطوية بكامل أطيافها، سواء كانت بعثية أو جهادية، وتأسيس دولة تقوم على العدالة، والمواطنة، وتوزيع السلطة، وليس على زعامات فردية تتغذى من الحروب والانقسامات.
تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعود إلى كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن موقف منصة رادار سوريا أو توجهاتها التحريرية.