سَالِي عُبَيْد – باحثة في شؤون الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية
حين تفقد الدولة عقلها، لا تفقده دفعة واحدة، بل كما يفقد الكائن ذاكرته على مهل، حتى يغدو جسدًا يتحرك بلا وعي، ويعتاد العطب كما يعتاد النفس. تبدأ الفوضى حين تتحول الإدارة إلى روتين، والقانون إلى ديكور، والسياسة إلى غنيمة. عندها تغدو الدولة كيانًا بلا غاية، يكرر نفسه باسم البقاء. لا تسقط الدول عادة بالانقلابات ولا بالاحتلالات، بل بالاعتياد على الرداءة، وبقبول ما لا يُقبل، وبالتحايل على الحقيقة حتى تصبح الكذبة نظامًا. حينها لا يبقى من مؤسساتها إلا جدران، ولا من سيادتها إلا الشعارات، ولا من الشرعية إلا الذاكرة. وما نراه اليوم في المشرق العربي عامة، وفي سوريا خاصة، ليس أزمة اقتصادية أو سياسية وحسب، بل انهيار في بنية العقل المؤسسي ذاته، العقل الذي يفترض أن يكون مركز الوعي الجمعي والضمير الإداري والسياسي للأمة.
العقل المؤسسي ليس وثيقة ولا دستورًا فحسب، بل هو المنظومة التي تنظّم العلاقة بين الفكرة والوظيفة، بين السلطة والمعنى. حين ينحرف هذا العقل عن غاياته، تتحول المؤسسات من أدواتٍ للعدالة إلى أدواتٍ للهيمنة، ويغدو الولاء بديلاً عن الكفاءة، والطائفة بديلاً عن المواطنة، والإدارة وسيلة لتكرار نفسها دون وعيٍ بجدوى وجودها. هنا يفقد النظام قدرته على التجدد، وتفقد الدولة قدرتها على إنتاج المعايير التي تحفظها من الانحلال. هذا ما يسميه فرانسيس فوكوياما “التآكل السياسي”، حين تصبح البيروقراطية شبكةً لحماية ذاتها، لا لخدمة المصلحة العامة. وفي هذه اللحظة تبدأ الدولة بالانكماش في داخلها حتى تغدو مثل حيوانٍ يلتهم أطرافه ليبقى حيًا.
وقد فهم ابن خلدون هذا منذ قرون حين قال إن الدولة تُبنى بالعصبية وتفنى بفسادها. فحين تضعف العصبية الجامعة، تحل محلها الولاءات الصغيرة: قبيلة، طائفة، حزب، أو فئة. أما كارل بوبر فحذّر من الوجه الآخر لهذا الفساد، وهو ما سماه “الشمولية الأخلاقية”، حين تُقدَّم مصلحة الدولة العليا ذريعة دائمة لإسكات المجتمع وتبرير القمع، فيتحول الكيان السياسي إلى غاية في ذاته، والمواطن إلى أداةٍ لبقائه. وهكذا يفقد الكيان معناه قبل أن يفقد قدرته. تصبح الدولة آلة تدير الزمن بدل أن تصنع المستقبل، وتتحول السلطة إلى نُسخة من نفسها، تُعيد إنتاج أخطائها تحت مسمياتٍ جديدة.
لكن التاريخ يقدّم لنا دائمًا أمثلة مضادة، تجارب نادرة استطاعت أن تستعيد عقل الدولة حين بدا أن كل شيء قد انتهى. ثلاث مدارس تتكامل وتفسّر كيف يُستعاد الوعي من تحت الركام: زايد في الإمارات، والخوري في سوريا، وبوكيلة في السلفادور. ثلاث لحظات مختلفة في المكان والزمان، لكن يجمعها وعيٌ واحد: أن الدولة لا تُبنى بالقوة وحدها، بل بالعقل الذي يعرف كيف يستخدمها.
قبل زايد، لم تكن الإمارات دولة بالمعنى المؤسسي. كانت سبع مشيخاتٍ صغيرة متناثرة على رمال الخليج، تعيش على الصيد واللؤلؤ، محكومة بعلاقات قبلية أكثر منها قانونية، ترتبط ببريطانيا بمعاهدات حماية، وتفتقر إلى بنيةٍ تعليمية أو اقتصادية أو إدارية. كانت الجغرافيا أكبر من الوعي، والهوية غائمة بين البحر والصحراء. لكن في هذا الفراغ ولد وعيٌ استثنائي لدى رجلٍ رأى في الفقر فرصة للتأسيس، لا عائقًا للنهضة. الشيخ زايد لم يبدأ من المال، بل من الفكرة. فهم أن التنمية ليست رفاهية، بل شرط وجود، وأن الدولة ليست سلطة بل عقدٌ إنسانيٌّ بين الحاكم والمواطن. لذلك، حين بدأ مشروعه، لم يبدأ بالقصور بل بالمدارس، ولم يستثمر في الجيوش بل في الإنسان. رأى أن الكرامة تسبق القوة، وأن الثروة بلا عدالة تهدم الدولة كما يهدمها الفقر بلا وعي.
في فلسفته السياسية، السيادة لا تُقاس بالجيش بل بقدرة الدولة على تحقيق الأمن الإنساني: أمن التعليم، وأمن الصحة، وأمن الفرص. لقد حوّل زايد الكفاءة إلى مصدر شرعية، وجعل من العمل العام عبادةً مدنية، لا وسيلةً للنفوذ. في رؤيته، رأس المال البشري هو جوهر الاستقلال، والتنمية ليست بديلاً عن السياسة بل هي السياسة حين تُمارس بعقلانية. كانت شرعيته نابعة من أثرٍ ملموس في حياة الناس، لا من شعاراتٍ أو أيديولوجيات. ومن هنا أوجد ما يمكن تسميته “شرعية الإنجاز” التي تحمي الدولة من التآكل وتربط الولاء بالفعل لا بالدم. لم يُرد زايد أن يؤسس جهاز حكم بل مشروع حضارة. فربط الثروة بالواجب، والهوية بالمواطنة، وجعل من الاتحاد صيغة عقلانية للتماسك في وجه الفراغ الإقليمي. تلك كانت لحظة استعادة العقل من العادة، حين عاد الحكم إلى معناه الأخلاقي الأول: خدمة الإنسان.
أما في سوريا، فالقصة كانت معكوسة تمامًا. فقبل فارس الخوري، كانت الدولة قائمة في الشكل وغائبة في الوعي. بعد سقوط العثمانيين، قسمت فرنسا المشرق كمن يقطع جسدًا حيًا. فرضت دويلاتٍ طائفية لتفتيت المجتمع: دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة جبل الدروز. ثم وضعت “حماية الأقليات” ذريعةً لبقائها، فيما كانت في الواقع تصنع أقليات لتبرر وصايتها. كان السوريون ممزقين بين قوميين، وإسلاميين، وعشائريين، وليبراليين، كلٌّ يراها دولة على مقاسه. هنا خرج فارس الخوري ليقول ما لم يقله أحد: إن الدولة لا تُبنى على العصبية بل على العقد، ولا على الانتماء الديني بل على المواطنة المتساوية. لم يكن الخوري زعيمًا سياسيًا بقدر ما كان مهندسًا للفكرة المدنية، مؤمنًا بأن العدالة هي الميثاق الوحيد القادر على جمع الناس.
حين وقف الخوري على منبر الجامع الأموي يخطب باسم المسيحيين أمام المسلمين، كان يعلن ثورة فكرية في وجه الانتداب الذي زعم حماية الأقليات. قال للفرنسيين إن المسيحيين لا يحتاجون إلى حماية أجنبية، وقال للمسلمين إن المواطنة لا تُقاس بالعقيدة. بتلك اللحظة، نقل فكرة الوطن من مستوى الشعار إلى مستوى العقد الأخلاقي. أراد أن يُحرّر الدين من السياسة دون أن ينفي دوره الروحي، وأن يجعل الدولة حَكَمًا بين الناس لا طرفًا فوقهم. كان يرى في الدستور عقل الدولة، وفي سيادة القانون ضمانة حريتها. بهذا الوعي، أرسى أولى لبنات العقل الدستوري في الشرق، حين ربط بين القانون والسيادة، وبين الحرية والمسؤولية. لقد فهم أن العدالة لا تتجزأ، وأن حماية الأقليات لا تكون بتقاسم الدولة بل بإصلاحها.
لكن بعد الخوري، انقلبت المعادلة. جاء البعث فحوّل المواطنة إلى أداة أمنية، والقانون إلى شعار حزبي، والدولة إلى جهاز رقابةٍ على العقول. تحولت الجمهورية إلى مزرعة، والعقل إلى خطرٍ على النظام. ولو عاش الخوري ليرى ما آل إليه وطنه، لقال إن أخطر أشكال الاستبداد هي تلك التي ترفع شعار الوحدة بينما تمزق المجتمع من الداخل. لقد مات العقل المؤسسي السوري حين صار الولاء للحزب أهم من الولاء للقانون، وحين صار الأمن أداةً للخوف لا للحماية.
وفي الطرف الآخر من العالم، عرفت السلفادور تآكلًا من نوعٍ آخر. بعد حربٍ أهليةٍ دامية دامت اثني عشر عامًا، خرجت البلاد منهكة، بلا مؤسساتٍ قادرة ولا ثقةٍ بين الدولة والمجتمع. تحولت العصابات إلى سلطاتٍ موازية، تفرض الإتاوات، وتدير الأحياء، وتقتل باسم البقاء. الشرطة فاسدة، والقضاء صوري، والناس رهائن الخوف. كانت الدولة مجرد واجهةٍ للعجز. وهنا ظهر نجيب بوكيلة، القادم من خارج الطبقة السياسية، لا بوصفه منقذًا شعبويًا، بل كمهندسٍ إداريٍّ يريد أن يعيد ضبط الدولة. رفض منطق التسويات الذي عاش عليه النظام القديم، وأعلن أن القانون يجب أن يكون عقل الدولة لا غطاءها. واجه الجريمة بالانضباط لا بالفوضى، وبالمحاسبة لا بالشعارات. بنى مؤسساتٍ رقمية تعتمد الشفافية، وأعاد هيكلة الأجهزة الأمنية لتخضع للقانون لا للعصابات. خلال سنواتٍ قليلة، انخفضت الجريمة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد، واستعاد المواطن الثقة بالدولة بوصفها حامية لا خصمًا.
لم تكن تجربة بوكيلة مثالاً للاستبداد الجديد كما يصوّرها البعض، بل مثالًا على الدولة التي تستعيد انضباطها لتستعيد عقلها. فالقوة، في فلسفته، ليست نقيض العدالة، بل شرطها حين تُمارس في إطار القانون. لقد بيّن أن الدولة القوية ليست تلك التي تُخيف، بل التي تَضبط نفسها قبل أن تضبط غيرها، وأن النظام حين يُحكَم بالعقل يصبح أخلاقًا لا قهرًا.
ثلاث تجارب إذًا: زايد، الخوري، وبوكيلة؛ ثلاثة نماذج للعقل المؤسسي في لحظات الانهيار. زايد أعاد تعريف التنمية بوصفها مشروعًا إنسانيًا، والخوري أعاد تعريف العدالة بوصفها أساس الشرعية، وبوكيلة أعاد تعريف النظام بوصفه شرط الثقة. هذه النماذج ليست وصفات جاهزة، لكنها تشترك في معادلة واحدة: أن الدولة لا تُبنى إلا حين يُعاد وصل الفكر بالفعل، والغاية بالوسيلة، والإنسان بالمؤسسة. التنمية التي تجعل الإنسان غاية، والعدالة التي تجعل القانون هوية، والانضباط الذي يجعل النظام عقلًا حيًا — هذه هي أضلاع مثلث الدولة العاقلة. فالتنمية تحمي من التفكك، والعدالة تحصّن من الفساد، والانضباط يمنع الفوضى. حين تتكامل هذه العناصر، تنتقل الدولة من إدارة البقاء إلى إنتاج المستقبل.
وما بعد الدولة، في هذا المعنى، ليس فراغًا سياسيًا، بل مستوى أرقى من التنظيم، حيث تتحول الحكومة من سلطةٍ فوقية إلى منظومةٍ معرفيةٍ تدير نفسها بالبيانات والمساءلة. تُعاد هيكلة الطبقة البيروقراطية على أساس الكفاءة لا الولاء، وتُعاد صياغة العقد الاجتماعي ليصبح شراكة لا وصاية، ويتحول الأمن من وظيفةٍ قسرية إلى غايةٍ إنسانية. عندها تصبح الدولة نظامًا فكريًا أكثر منها جهازًا ماديًا، ويصبح الولاء عقلانيًا لا غريزيًا.
وفي الحالة السورية تحديدًا، يتبدى هذا التحليل بوصفه ضرورة وجودية لا ترفًا فكريًا. فالوضع في سوريا اليوم يمثل صورةً مركبة لانهياراتٍ ثلاث: غياب الوحدة كما كانت الإمارات قبل الاتحاد، وتفكك الطوائف كما كانت سوريا قبل الخوري، وفوضى السلاح والعصابات كما كانت السلفادور قبل بوكيلة. كل القوى الدولية تستفيد من بقاء هذا الجمود: روسيا وإيران تحتكران النفوذ، إسرائيل تحوّل الحدود إلى منطقة أمنية عازلة، تركيا توازن بين الفوضى والاستثمار السياسي، والغرب يتعامل مع المأساة بوصفها ملفًا إداريًا لا قضية أخلاقية. في الداخل، المعارضة متآكلة، والسلطات المحلية تحكم بسلطة التهريب والخوف، والمجتمع بين النجاة الجسدية والموت المعنوي. سوريا لم تعد وطنًا، بل ساحة تفاوضٍ بالدماء.
غير أن هذا الواقع، مهما بدا محكمًا، ليس قدرًا. لأن التحول في التاريخ لا يبدأ من الخارج، بل من لحظة استعادة الداخل لعقله. لن يحرّر السوريين مؤتمر دولي ولا صفقة حدود، بل استعادة وعيهم بالمؤسسة بوصفها ملكًا عامًا لا أداة سلطة. حين يدرك السوري أن الدولة ليست عدوًا له بل انعكاسه، يبدأ التغيير الحقيقي. وعندما يُعاد بناء العقد الاجتماعي على قاعدة المواطنة لا الطائفة، ستُولد الدولة الجديدة لا من رحم القوة، بل من رحم العقل.
إعادة بناء الدولة السورية لا تعني ترميم الخراب بل تجاوز النموذج كله. فالدولة الجديدة يجب أن تُبنى على شرعية الإنجاز لا الولاء، وعلى العدالة لا على الانتقام، وعلى انضباط القانون لا على فوضى السلاح. في نموذج زايد، يمكنها أن تتعلم كيف تجعل التنمية فعل سيادة، وفي نموذج الخوري كيف تجعل المواطنة هوية جامعة، وفي نموذج بوكيلة كيف تجعل الانضباط وسيلة للثقة لا للخوف.
حين تتكامل هذه الأبعاد الثلاثة، يمكن لسوريا أن تتحول من مسرحٍ للوصايات إلى كيانٍ عاقل. الأمن يصبح أداةً للثقة لا وسيلةً للهيمنة، العدالة تتحول إلى مؤسسةٍ لا إلى شعارٍ سياسي، والتنمية تصبح فعلًا اجتماعيًا يشارك فيه المواطن. هذه ليست نظريات، بل تطبيقاتٍ ناجحة في أماكن أخرى، والفرق الوحيد هو الإرادة. في النهاية، الدولة التي تفكر لا تموت، حتى لو انهارت مؤقتًا. والدولة التي تخاف من عقلها تموت ولو كانت غنية وقوية. زايد جعل من التفكير سياسة، والخوري جعل من القانون إيمانًا، وبوكيلة جعل من النظام أخلاقًا. وسوريا لن تُستعاد إلا إذا استعادت عقلها الجمعي، ذاك الذي يعرف أن الوطن ليس طائفة ولا صفقة، بل فكرةٌ لا تعيش إلا بالعقل. حين تعود الدولة إلى التفكير، تعود الأمة إلى الحياة. وسوريا اليوم، إن أرادت النجاة، فعليها أن تبدأ من هناك من نقطة التفكير الأولى.
تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعود إلى كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن موقف منصة رادار سوريا أو توجهاتها التحريرية.
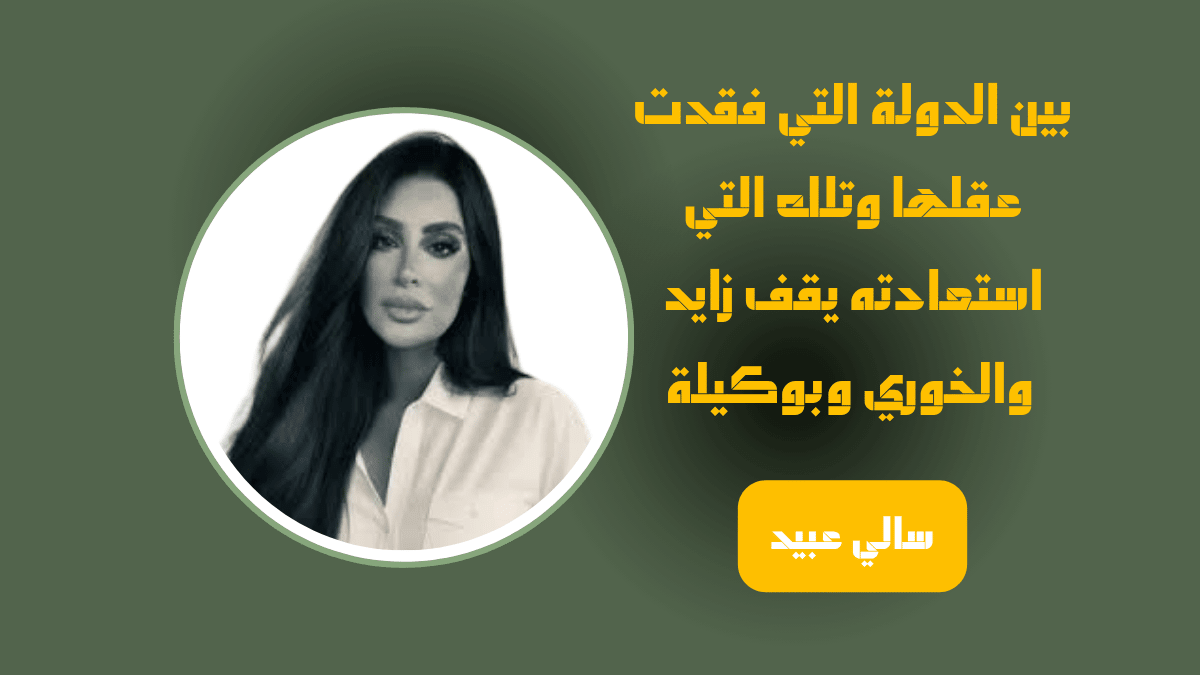
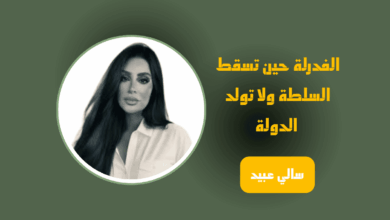 الفدرلة .. حين تسقط السلطة ولا تولد الدولة
الفدرلة .. حين تسقط السلطة ولا تولد الدولة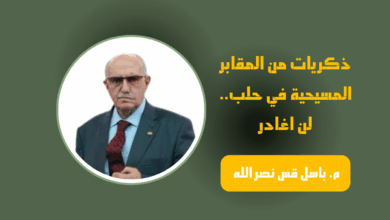 ذكريات من المقابر المسيحية في حلب.. لن اغادر
ذكريات من المقابر المسيحية في حلب.. لن اغادر